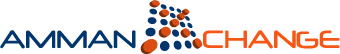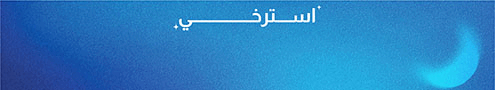المواضيع الأكثر قراءة
- %52 من الملاحظات الرقابية لـ"المحاسبة" بلا تصويب.. ثغرات قانونية وتراخ مؤسسي
- بناء "السمعة الرقمية".. مهمة ليست سهلة والثقة أساس النجاح
- فاتورة المياه تستنزف الموازنة.. مديونية القطاع تقفز إلى 3 مليارات دينار
- خبراء: تقدم الأردن في قطاع الطاقة المتجددة يتطلب خطوات سريعة
- عقاريون يتوقعون تحسن الطلب على الشقق السكنية نهاية أيلول
- تراجع تفاؤل الأميركيين بسوق العمل يعزز توقعات خفض الفائدة
- سلسلة ارتفاعات للاقتصاد السعودي بقيادة الأنشطة غير النفطية
%52 من الملاحظات الرقابية لـ"المحاسبة" بلا تصويب.. ثغرات قانونية وتراخ مؤسسي

الغد-محمود الشبول
واقع مقلق، يكشف عنه تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، برغم وضوح النصوص القانونية الناظمة لدور ديوان المحاسبة، وتعدد التقارير السنوية التي تسجل ملاحظات على المؤسسات، ما تزال الاستجابة لهذه المخرجات محدودة، ما يعكس ثغرات في منظومة الرقابة والمتابعة.
وقد تتبعت "الغد" مؤشرات تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات الديوان التي وردت في التقرير، مدعّمة ببيانات وأرقام رسمية، وبالرجوع للنصوص القانونية ذات الصلة.
وفي مشهد يعكس فجوة في منظومة الرقابة المالية والإدارية في الأردن، يكشف التقرير أن 48 % من الملاحظات الرقابية التي وجهت للمؤسسات الرسمية جرى تصويبها، في وقت يفرض فيه القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، التعاون الكامل والاستجابة خلال سقف زمني محدد.
وقد بلغ عدد المخرجات الرقابية وفقًا للبيانات الواردة في التقرير: 417 مخرجًا، شملت 4883 ملاحظة رقابية موزعة على 141 جهة رسمية، إذ جرى تصويب 2366 ملاحظة، أي أن أكثر من 2500 ملاحظة بقيت بلا معالجة حتى تاريخ إعداد التقرير، وهي نسبة تثير تساؤلات حول فعالية الرقابة اللاحقة في ظل غياب عقوبات واضحة للجهات المتقاعسة عن التصويب.
تفاوت الاستجابة بين الجهات
يشير التقرير لتفاوت كبير في نسبة الاستجابة بين الوزارات والمؤسسات، فبينما تجاوبت جهات وبنسبة تفوق الـ80 %، شهدت وزارات حيوية وجهات أخرى، كالبلديات، ووزارات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50 %، تراجعا ملحوظا في نسب الاستجابة، إذ لم تتجاوز نسب التصويب في بعض الحالات %36 فقط، ما يثير تساؤلات حول جدية التعاطي مع الملاحظات الرقابية.
مديرية التفتيش بوزارة الإدارة المحلية، ردت على استفسارات "الغد" حول تدني نسبة الاستجابة في البلديات إذ "استجابت لـ317 بندا من أصل 866 بندا"، أي أن ضعف استجابة البلديات يعود لعدم التزام رؤساء بلديات وموظفين بالتصويب، مضيفة أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة تفعيل وحدات الرقابة الداخلية، وإضافتها للهياكل التنظيمية لهذه البلديات، واعتمدت مسارا تدريبيا بالمشاركة مع الديوان ومعهد الإدارة العامة، لبناء قدرات الموظفين المعنيين باللجان والرقابة، إذ جرى تدريب 2000 موظف، وستجري المتابعة معه لتفعيلها.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أكد لـ"الغد" بشأن استجابة الوزارة لـ23 % فقط من مخرجات التقرير، التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع الديوان، وتفعيل الرقابة الداخلية لضمان تصويب الملاحظات الرقابية وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
وبيّن المحارمة، أن الوزارة اعتمدت آلية عمل مؤسسية، تستند لتعميم وزير الأشغال، تُحول بموجبها المخرجات الرقابية فور ورودها لوحدة الرقابة الداخلية، بالتنسيق مع المديريات المعنية، لإعداد الردود وتزويد الديوان بالوثائق المعززة. مشيرا لتشكيل لجنة مشتركة مع مندوب من الديوان، تتابع دوريا البنود غير المغلقة، وترفع تقارير فصلية توضح أسباب عدم استكمال التصويبات.
غياب المحاسبة الحقيقية
برغم الصلاحيات القانونية للديوان الذي يستند بأعماله إلى قانون الديوان رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته والذي ينص "على أن يتولى الديوان مراقبة كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ويقوم بإعداد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء"، وبرغم إلزام قانون الديوان للجهات الخاضعة للرقابة بالإجابة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ وصوله للجهة، فإن هناك تراخيا لدى جهات في تشكيل لجان تصويب، يفتح الباب للتساؤل عن جدوى الرقابة من دون أدوات تنفيذية واضحة، حاولت "الغد" الحصول على إجابات من الديوان ووزارة الصحة، لكنها لم تتلق أي رد لغاية نشر التقرير.
وتنص المادة (16) قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، أنه "على أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإجابة على أي استيضاح، يوجهه إليها الديوان ضمن نطاق مهامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما اعتبارا من تاريخ وصوله إلى تلك الجهة، إذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز 60 يوما إذا كان مركز عملها خارجها".
من جهتها، بينت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية الأردن) في ردها على أسئلة "الغد" أن تدني نسبة استجابة الجهات الرسمية لملاحظات الديوان، والتي لم تتجاوز الـ48 % حسب تقرير 2023، لا تعكس فقط ضعفًا إداريًا، بل تمثل مخالفة صريحة للمادة (16) من قانون الديوان رقم 28 لسنة 1952، التي تُلزم بالرد خلال 30 يومًا في المملكة و60 يومًا خارجها.
وبرغم تعديل النص القانوني في عام 2022 ليضيف عبارة "تحت طائلة المسؤولية القانونية"، لكن النص ظل عامًا دون تحديد واضح للعقوبات، ما يُضعف من أثره الردعي بحسب رد "رشيد".
صمت 47 جهة حكومية
لا تكمن المشكلة بتدني نسبة التصويب، بل في أن 47 جهة حكومية لم تزود بالبيانات والمعلومات المطلوبة، ما يعيق عمل الديوان باستكمال مهامه الرقابية، وهو ما يمكن وصفه بـ"الصمت المؤسسي" الذي يقوّض جوهر المساءلة العامة.
وبحسب "رشيد" فإن عدم الرد، وفقًا للمادة (21) من القانون ذاته، يُعرض الجهة للمساءلة، لكن الآلية غائبة. هذا الغموض في التشريعات، فتح ثغرات قانونية تتيح التهرب أو المماطلة، بخاصة في ظل غياب التمييز بين الإهمال المتعمد وغير المتعمد، مشددة على عدم وجود عقوبات إدارية أو مالية واضحة، برغم وضوح المخالفات وتكرارها سنويا، ما يتطلب تعديل المادة (16) تتضمن عقوبات على عدم الرد أو المماطلة، كما يجب تفعيل دور مجلس النواب بمحاسبة الجهات التي "لا تلتزم".
وتجد "رشيد" ضرورة منح الديوان سلطة إصدار قرارات إلزامية، وصلاحيات الضابطة العدلية الكاملة وتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، وتضمين صلاحيات واضحة للديوان بإحالة المخالفين للنيابة العامة بشكل مباشر. مؤكدة أن هنالك إشكالية الاستقلالية الناقصة للديوان في بعض الجوانب، إذ يتدخل مجلس الوزراء بتعيين رئيس الديوان وتحديد اختصاصاته، ومن يملك صلاحية التعيين يملك صلاحية السحب، مع أن الأصل بأن تكون مرجعية الديوان للسلطة التشريعية وليست للتنفيذية.
كما يكشف تدني نسب الاستجابة لملاحظات الديوان، عن خلل أعمق في منظومة الرقابة الإدارية والمالية، وهذا لا يتعلق فقط بثغرات في آليات التصويب أو ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بل يمتد لقصور تشريعي وتشغيلي يحتاج لمراجعة جذرية. فالنصوص القانونية القائمة، برغم وضوحها في الإلزام، تفتقر لأدوات إنفاذ حقيقية، وتغيب عنها العقوبات الصريحة والمباشرة، ما يفتح الباب أمام التراخي أو التهرب المؤسسي، كذلك "عدم وجود نص صريح للإحالة المباشرة للسلطة القضائية في حال مخالفة الجهات الخاضعة لتطبيق القانون"، وفق "رشيد".
غياب التوصيف الإجرائي
ويزيد من تعقيد المشهد، غياب التوصيف الإجرائي لمسؤولية التقاعس أو الامتناع عن الرد، وتراجع استقلالية الديوان في جوانب حساسة، ما يستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني الحاكم لعمله، بما يعزز من صلاحياته، ويمنحه أدوات تنفيذية ومحاسبية أكثر فعالية، ويكرّس مرجعيته الرقابية كسلطة تشريعية مستقلة، وفق المعايير الدولية الفضلى. فالإصلاح المؤسسي في هذا السياق، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتجسيد مبدأ الرقابة الحقيقية على المال العام، وحماية النزاهة في الإدارة العامة. لكن المشكلة لا تكمن بتدني نسب التصويب حسب، بل في غياب الإرادة المؤسسية لإغلاق ملفات المخالفات، وسط فراغ تشريعي يسمح بالإفلات من الرد والمساءلة.
ومع تعاظم التحديات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على المال العام، تصبح الحاجة ملحّة لإصلاح جذري في بنية الرقابة، يرتكز على تمكين الديوان بصلاحيات إنفاذ فعلية، وتفعيل دور البرلمان، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية. فالمساءلة ليست خيارًا بيروقراطًيا، بل شرطا أساسيا لحماية المال العام وبناء دولة المؤسسات.