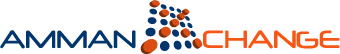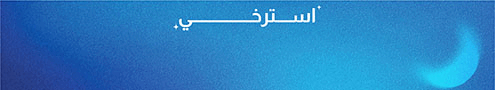المواضيع الأكثر قراءة
- 400 مليون دولار قرض ميسر من البنك الدولي لإصلاح القطاع الصحي
- عودة "خدمة العلم".. فرصة لاستثمار رأس المال البشري ورفع كفاءة الأجيال
- "الرديات الضريبية" محفز فوري للاستهلاك الداخلي
- المياه.. ماذا ننتظر بعد بلوغ "الخطوط الحمراء"؟
- تعديلات "الضمان".. دعوات لحوار وطني موسع
- «وول ستريت» تتماسك قبيل أسبوع حاسم لـ«الفيدرالي» وأرباح التجزئة
- %3.7 زيادة المطاعم السياحية
التمييز في سوق العمل: حين تُقاس الكفاءة بالجنسية… والشهادة*محمد جودت الرفاعي

الراي
في عالم يُفترض أنه بات أكثر انفتاحاً وشمولاً، ما زال البعض يُقيَّم لا بما يعرف، بل بما يحمل من أوراق ثبوتية، وأين جلس على مقاعد الدراسة.
ففي ممرات بعض الشركات، لا يُقاس الإنسان بما يحمل من معرفة أو خبرة، بل بما تحمله جوازات سفره من “امتيازات”، إذ تُجرى مقابلات العمل وكأنها اختبار للهوية لا للكفاءة، ويُفصل المتقدمون عن بعضهم البعض بأسلاك غير مرئية من التحيّز، حيث يصبح لون البشرة، أو مكان الولادة، أو جنسية الجواز، أو اسم الجامعة المدونة في سيرهم الذاتية، معياراً غير معلن لتحديد الأجور والفرص.
ولكن التحيّز لا يقف عند حدود الجنسية وحدها، بل يمتد ليشمل نوعية الشهادة التعليمية ومصدرها، ففي كثير من المؤسسات، تُمنح الأولوية لحملة الشهادات من الجامعات الغربية، حتى وإن كانت جامعات متوسطة التصنيف، أو لم يثبت خريجوها تميزاً فعليًا في العمل، ومقابل ذلك، يُنظر بشك ضمني إلى خرّيجي الجامعات المحلية أو العربية، حتى وإن خرجوا منها بكفاءة عالية وتجربة مهنية مشهودة.
ويتجلى هذا الخلل بوضوح في المؤسسات الأكاديمية والجامعات، حيث تُمنح الأفضلية في التعيين لمن حصل على شهادته من جامعة أوروبية أو أمريكية، أو لمن يحمل جنسية أجنبية، حتى وإن لم يكن الأفضل من حيث النتاج العلمي أو المهارات التربوية.
وفي جامعات عربية مرموقة، بات من الشائع أن يُستبعد أكاديمي عربي يحمل شهادة دكتوراه من جامعة محلية محترمة، لصالح آخر يحمل جواز سفر أجنبي، رغم تشابه المؤهلات، وكأن الهيبة الأكاديمية لا تكتمل إلا بلكنة غربية أو سطر أجنبي في السيرة الذاتية.
وإنها لمفارقة مؤلمة: أن يُعتبر طالبٌ درس في الخارج، وبلغ مستوى أكاديميا عاديا، أكثر كفاءة من آخر تخرّج من جامعة عربية مرموقة، فقط لأن الشهادة جاءت من “العالم الأول”، وكأن المعرفة لا يُعتد بها إن لم تكن باللغة الإنجليزية، أو ممهورة بشعار جامعة تقع على الضفة الأخرى من الكرة الأرضية.
وهذا التحيز كله يجعل من “مصدر التعليم” عاملا حاسماً لا يعكس بالضرورة المهارة، بل يعكس امتيازا اجتماعياً واقتصادياً سابقاً، فتح أبواباً أُغلقت في وجه غيره.
وأصبحنا نرى في سوق العمل أمثلة حية: مدير تم تعيينه فقط لأنه يحمل شهادة من جامعة أوروبية، رغم محدودية خبرته، بينما يُقصى آخر يملك سجلاً مهنيا لامعا فقط لأن شهادته من “الداخل”، وهذا التمييز الإيجابي لحملة الشهادات الغربية، هو وجه ناعم من وجوه العنصرية المؤسسية، حتى وإن جاء مغلفاً بمصطلحات براقة مثل “المعايير العالمية” أو “الخبرة الدولية”.
وهذه الممارسات لا تقتل فقط روح التنافس الحقيقي، بل تزرع في بيئات العمل شعوراً بالغبن، وتخلق طبقية داخل المؤسسة نفسها، فحين يرى الموظفون أن الترقية مرتبطة بالجنسية أو البلد الذي درس فيه المدير، لا بالكفاءة أو الإنتاج، ينهار الإيمان بمنطق العدالة، وتتآكل دوافع الانتماء.
ولا ننكر أن بعض المؤسسات بدأت فعلاً بإعادة النظر في سياساتها، وحرصت على تحقيق التنوع والتوازن في الفرص، لكن الطريق لا يزال طويلاً.
وما نحتاجه لا يقتصر على قوانين تنظيمية، بل يتطلب تحولا ثقافياً في نظرتنا للإنسان العامل: أن يُقاس بما يُجيده، لا بما يُكتب في خانة “الجنسية”، أو على سطر “مكان التخرّج” في سيرته الذاتية.
وقد نكون قادرين على بناء بيئات عمل أكثر عدلًا وشمولًا، لكن الخطوة الأولى تبدأ بالاعتراف: الاعتراف بأن التمييز موجود، وأننا جميعاً بشكلٍ أو بآخر جزء من منظومة تُعيد إنتاجه يومياً، وحين نعترف، نكون قد بدأنا فعلاً أولى خطوات الإصلاح.