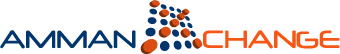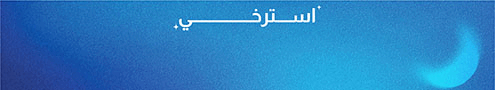المواضيع الأكثر قراءة
- "الأمية المهارية".. التحدي الجديد في مواجهة خفض أرقام البطالة
- أنظمة الذكاء الاصطناعي المفتوحة.. فوائد جديدة محفوفة بالمخاطر
- الأطر القانونية والإستراتيجية للتوقيع الرقمي(3-2)
- الأردن يحصل على برنامج أوروبي جديد للتمويل الأخضر قيمته 634 مليون دولار
- خبراء: القرارات الحكومية تسهم بزيادة القيمة السوقية لبورصة عمان
- ارتفاع معظم الأسواق الخليجية... والسعودية تقترب من أدنى مستوى في عامين
- "ملاحة الأردن": نمو ملحوظ في أداء ميناء العقبة
الأطر القانونية والإستراتيجية للتوقيع الرقمي(3-2)
الغد-د. حمزة العكاليك
وأما عن الأمان والموثوقية، فيعد التوقيع الرقمي أكثر أمانا من التوقيع اليدوي التقليدي. فهو يستخدم تدابير أمنية قوية وتقنيات تشفير متقدمة لضمان مصداقية الموقّع، كما ينشئ سجلا قابلاً للتدقيق (Audit Trail)، يوثق كل خطوة من عملية التوقيع. هذا السجل يعد دليلا قانونيا قويا يمكن استخدامه في حال نشوب نزاع، مما يعزز الثقة في سلامة المستندات والمعاملات.
إن الفوائد المباشرة المذكورة أعلاه، كالكفاءة والتكلفة، تعد مجرد آثار سطحية. فالمنفعة الاستراتيجية الأوسع، تكمن في تمكين الاقتصاد الرقمي ككل. كما إن وجود إطار قانوني وتقني موثوق للتوقيعات الرقمية يشجع التجارة الإلكترونية، ويسهل المعاملات المالية عبر الحدود، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز القدرة التنافسية للأردن على الساحة العالمية.
إن القيمة الحقيقية للتوقيع الرقمي تتجاوز مجرد الكفاءة التشغيلية، إلى تمكين استراتيجي شامل. يمكن تقييم العائد على الاستثمار (ROI)، لتبني التوقيع الرقمي من خلال محورين: التوفير المباشر والفوائد غير المباشرة.
إن الربط بين منصة "سند" الأردنية وتجربة سنغافورة في توحيد الهوية الرقمية، يعد نقطة قوة استراتيجية للأردن، حيث يمتلك بالفعل حجر الزاوية المطلوب لبناء منظومة رقمية متكاملة وموثوقة.
وعلى الرغم من الفوائد الواضحة، يواجه تطبيق التوقيع الرقمي تحديات متعددة يجب معالجتها بشكل استباقي، أولها: التحديات القانونية والقضائية، فعلى الرغم من أن القانون الأردني يمنح التوقيع الإلكتروني حجية قانونية، إلا أن القضاء الأردني ما يزال حذرا في التعامل معه، خاصة في الدعاوى التي تتطلب إثباتا قويا. وغالبا ما تطلب وسيلة إثبات إضافية في القضايا التي لا يتوفر فيها دليل موثوق لهوية الموقّع، مما يظهر الحاجة إلى تعزيز الثقة القضائية في الأنظمة الرقمية.
كما يعاني التحول الرقمي في بعض الدوائر الحكومي،ة من تحديات تقنية تتمثل في تكرار تعطل الأنظمة (System Downtime). وهذا التحدي لا يؤثر فقط على كفاءة الخدمة، بل يضرب الثقة في المنظومة الرقمية بأكملها. إضافة إلى ذلك، فإن غياب التكامل بين أنظمة الدوائر الحكومية المختلفة يفرض على المواطنين الانتقال بين المكاتب لإتمام معاملة واحدة، مما يبقي الحاجة إلى التعامل الورقي قائمة. هذا الوضع يقوض الجهود المبذولة لبناء الثقة التي هي أساس التوقيع الرقمي. كما ما يزال الوعي العام وثقافة التعامل مع المعاملات الرقمية، ضعيفين نسبيا لدى شرائح واسعة من المجتمع. فالموظفون والجمهور بحاجة إلى تدريب مستمر لتبني هذه التقنيات والاستفادة منها بشكل كامل.
إن المشكلة لعدم التكامل بين أنظمة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، هي عائق رئيسي أمام التحول الرقمي الحقيقي.
فلا بد من التكامل الأفقي، ويجب الاستثمار في بناء منظومة متكاملة تربط جميع الأطراف، حيث يمكن للمواطن إتمام معاملة واحدة منذ البداية إلى النهاية رقميا، من دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب.
وكذلك، فإن التكامل العمودي يعتبر ضمانا في أن تكتمل المعاملة رقميا بشكل كامل، بدءا من تقديم الطلب، مرورا بالتوثيق، وصولا إلى التوقيع والحفظ، من دون الحاجة للعودة إلى التعاملات الورقية.
ويمكن القول إن التحدي الأكبر في الأردن ليس تقنيا أو قانونيا بحتا، بل هو منظومي في جوهره. المشكلة لا تكمن في بناء خدمة واحدة (مثل التوقيع)، بل في ربط هذه الخدمة بسلسلة كاملة من المعاملات الحكومية والخاصة. غياب هذا الترابط يعني أن المواطن سيظل مجبرا على التعامل الورقي، مما يجعل التحول الرقمي مجرد واجهة لا تغني عن الإجراءات التقليدية.
إلا أن توجيه ولي العهد، بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مع التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر تطبيق "سند"، يشكل دافعا استراتيجيا حاسما. فهذا التوجيه يحمل دلالة عميقة، فوزارة العدل هي الحصن الأخير للمعاملات الرسمية والقانونية، ودمج التوقيع الرقمي في عملها يمنحه أعلى مستوى من الحجة القانونية والقبول المجتمعي. كما أن ربطه بتطبيق "سند" يؤسس منظومة وطنية موحدة للتحقق من الهوية والتوقيع. هذا التوجيه يمنح المشروع زخما سياسيا عاليا، ويضمن أولوية التنفيذ، مما يجعله أكثر من مجرد مبادرة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة.
ويعد قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، الإطار التشريعي الأساسي الذي يحكم التوقيع الرقمي في الأردن. فهذا القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية التحتية القانونية للمعاملات الإلكترونية والحد من حالات الاحتيال والتزوير. ومن أبرز أحكام هذا القانون أنه يمنح التوقيع الإلكتروني حجة قانونية، وتحدد أربعة شروط رئيسية لصحته، وهي: أن يكون فريدا لصاحبه، يحدد هويته، يتم إنشاؤه بوسائل تخضع لسيطرته ويرتبط بالسجل بطريقة تمنع التعديل من دون إحداث تغيير في التوقيع. كما يجيز القانون إنشاء جهات توثيق إلكترونية مرخصة لإصدار شهادات التوثيق.
وتشير التعديلات التشريعية المقترحة، مثل مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، وقانون الكاتب العدل لسنة 2025، إلى جهود حكومية حثيثة لمواكبة التطورات. ويهدف التعديل المقترح على قانون الكاتب العدل، إلى توسيع اختصاصه ليشمل جميع المحافظات، والسماح بإنجاز المعاملات إلكترونيا من خارج المملكة، ومنح المعاملات الإلكترونية الصفة القانونية الكاملة المماثلة للمعاملات الورقية. وتشكل هذه التعديلات خطوة حاسمة لتمكين التوقيع الرقمي من الخروج من نطاق المعاملات البسيطة إلى المعاملات الأكثر رسمية مثل، التوكيلات والمصادقة على المستندات، مما يمثل انتقالا من مجرد اعتراف بالقانون إلى تفعيل عملي للتوقيع الرقمي في صميم الحياة المدنية.
وتشهد الساحة الأردنية حراكا كبيرا على صعيد المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تفعيل التوقيع الرقمي، ومنها: مشروع وزارة العدل، حيث أعلنت الوزارة عن خطة لتطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم، بدءا بالمرحلة الأولى في محكمة بداية عمان. ستمكن هذه الخطوة القضاة والموظفين من توقيع الكتب والمذكرات القضائية رقميا، مما يزيد كفاءة معالجة القضايا ويقلل التعامل بالمستندات الورقية. وتعتبر منصة "سند"، البوابة الرئيسية للحكومة الرقمية في الأردن. تتيح المنصة للمواطنين تفعيل هويتهم الرقمية للوصول إلى الخدمات الحكومية وتوقيع المستندات رقميا. يمكن للمواطنين تفعيل هوياتهم الرقمية من خلال محطات "سند" المنتشرة في المملكة أو عبر البنوك المشاركة، مثل بنك الاتحاد وبنك الأردن.
وأما المبادرة التي أطلقها البنك المركزي الأردني "تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية (DiSiFi Challenge)"، فهذه تهدف إلى استغلال البنية التحتية القوية للمفاتيح العامة لديه. يدعو التحدي الشركات الأردنية الناشئة إلى تطوير حلول توقيع رقمي مبتكرة للمؤسسات المالية، بهدف تعزيز الابتكار المحلي بدلا من الاعتماد على حلول جاهزة من الخارج.
فالبنك المركزي الأردني يشكل قوة دافعة أساسية في قيادة منظومة التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في المملكة. يتجاوز دوره التقليدي كجهة تنظيمية ليشمل كونه محفزا للابتكار، راعيا للشركات الناشئة وبانيا للبنية التحتية اللازمة لمستقبل مالي رقمي. إن مبادرة "تحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية (DiSiFi Challenge)"، مثال حي على هذا الدور الرائد، حيث تقترن بجهود أخرى للبنك المركزي لتعزيز الريادة والابتكار.
ويعد تحدي "DiSiFi" مبادرة مبتكرة، تهدف إلى معالجة الفجوة في استخدام التوقيع الرقمي في القطاع المالي الأردني. على الرغم من وجود بنية تحتية قوية للمفاتيح العامة (PKI)، لدى البنك المركزي، إلا أن إمكانات التوقيع الرقمي لم تستغل بشكل كامل. هنا يكمن دور البنك المركزي في تحفيز الشركات المحلية من خلال هذا التحدي، الذي يوجه الشركات الناشئة الأردنية لتطوير حلول توقيع رقمي متقدمة ومتوافقة مع البنية التحتية القائمة، بدلا من الاعتماد على حلول جاهزة من الخارج.
وتظهر المواصفات التقنية للتحدي، مدى عمق تحليل البنك المركزي للاحتياجات الفنية، حيث يشترط أن تدعم الحلول المقدمة تنسيقات توقيع مختلفة مثل PDF وJSON
وXML، إضافة إلى القدرة على التعامل مع مستويات مختلفة من التواقيع (B, B-T, LT, and LTA). كما يفرض التحدي على الشركات الفائزة، أن تكون قادرة على تنفيذ إثبات المفهوم (Proof of Concept) في غضون 60 يوماً من إعلان الفوز، مما يضمن الانتقال السريع من الفكرة إلى التطبيق العملي.