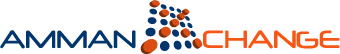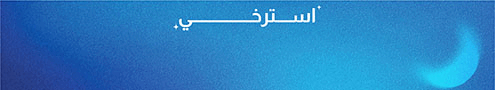المواضيع الأكثر قراءة
- كيف يمكن الحد من تأثير الهواء على قيمة فاتورة المياه؟
- "المنتدى الاقتصادي".. 100 مليون دينار حجم مشاريع صندوق الطاقة في الأردن
- %47 تراجع طلبات رخص "المصادر الطبيعية"
- "الإستراتيجية الوطنية": تطويع الابتكار والريادة لإنجاز التحول الرقمي
- تدفقات صناديق الأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً
- رئيس «فيدرالي نيويورك»: على البنوك المركزية الاستعداد للتغيرات غير المتوقعة
- الملكية الأردنية وزين تطلقان الترجمة الفورية بــلـغـة الإشــارة للصــم
الأردن والمياه العابرة للحدود.. تحديات تتطلب تحركات عاجلة

الغد-إيمان الفارس
مع تصاعد التحذيرات من احتمالية اندلاع صراعات إقليمية بسبب النزاع على الموارد المائية، وفي مقدمتها المياه المشتركة، يواجه الأردن تحديا وجوديا يتجاوز حدود العجز المائي التقليدي، ليطال مفاهيم السيادة والأمن القومي.
ورأى خبراء في قطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، أن التأخر في معالجة هذا الملف؛ ينذر بتفاقم التوترات مع دول الجوار، في وقت أصبحت فيه المياه أداة ضغط سياسي وإستراتيجي.
وفي مواجهة هذا الواقع المعقّد، اقترح المختصون حزمة من الإجراءات العاجلة، تبدأ بإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتتوافق مع قواعد القانون الدولي، مرورا بتفعيل أدوات الدبلوماسية المائية والتعاون متعدد الأطراف، وصولا إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع الحفر والتنقيب عن المياه العميقة، والتوسع في تحلية مياه البحر ضمن مشاريع كبرى كـ"الناقل الوطني".
وهي خطوات يرون أنها لم تعد خيارا، بل ضرورة لمواجهة أزمة تتجاوز بعدها البيئي لتتحول إلى أحد أبرز مهددات الاستقرار في المنطقة.
ففي قلب النزاعات المشتعلة في الشرق الأوسط، تعيد أزمة المياه رسم خريطة الصراع في المنطقة، متجاوزة حدود التنافس الجيوسياسي التقليدي على النفط، لتصبح المياه هي محور الهيمنة والتحكم والبقاء.
فالمملكة، التي تعد أكثر الدول فقرا في المياه عالميا، تواجه عجزا مائيا متفاقما يتجاوز 500 مليون متر مكعب سنويا، ما يجعل تأمين المياه للمواطنين مهمة معقدة تعصف بها أزمات إقليمية، وتغذيها النزاعات حول الموارد المشتركة وتغير المناخ.
ومع اعتماد الأردن بشكل كبير على مصادر خارجية للمياه، أصبح توزيع المياه مرتبطا بتحولات سياسية وأمنية لا تخلو من التوتر، حيث أثرت الانسدادات الإقليمية وتراجع تدفق الأنهار المشتركة بشكل مباشر على حصة المملكة، في ظل صمت دولي.
وهذه الأزمة لا تنفصل عن السياق الأوسع في الشرق الأوسط، حيث تحوّلت المياه من مورد طبيعي إلى أداة صراع ونفوذ، تستخدم من قبل دول وجماعات لتعزيز السيطرة وفرض الهيمنة.
ومع استمرار الجفاف، وغياب الإرادة الدولية لحماية الحقوق المائية، تصبح العدالة المائية أحد أكبر الرهانات السياسية والإنسانية في المنطقة.
تحذيرات مستمرة
وفيما حذر تقرير صدر مؤخرا عن الموقع الدولي "ميدل إيست مونيتور"، وحصلت "الغد" على نسخة منه من تهديدات تغير المناخ وانعكاسه على تفاقم أزمات المياه، وخاصة في الشرق الأوسط الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وموجات جفاف طويلة الأمد، أكد الخبراء، أن الأردن يمرّ بواحدة من أخطر الأزمات المائية في المنطقة، نتيجة تعقيدات داخلية وخارجية تشمل الاعتماد الكبير على مصادر مياه مشتركة، والضغوط المناخية والديموغرافية، والاختلالات في الاتفاقيات الإقليمية المنظمة لتقاسم المياه.
ووسط تسليط التقرير الدولي الصادر مؤخرا عن جامعة "جونز هوبكنز" الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، بوصفه أحد الأعمدة الأساسية للخروج من مأزق ندرة المياه التي تُصنّف اليوم كقضية وجودية في المملكة، أشار المختصون، إلى أن المياه المشتركة تشكل ما نسبته 40 % من موارد المياه في الأردن، إلا أن الاستخدام الفعلي منها لا يتجاوز 20–25 %.
واعتبر هؤلاء أن الاتفاقيات المبرمة منذ عقود، مثل اتفاقية جونستون (1953–1955)، أصبحت غير منصفة، ولا قادرة على تلبية المتطلبات الحالية، في ظل متغيرات مناخية وجيوسياسية وديموغرافية عميقة.
وشددوا على ضرورة تحديث هذه الاتفاقيات، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 لاستخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة، والتي تُعد مرجعًا أساسيًا لتوزيع المياه على أسس من العدالة وعدم الإضرار.
كما أوصوا بضرورة إعادة تشكيل اللجان الفنية المشتركة لتضم خبراء متخصصين في المياه السطحية والجوفية، مع إنشاء لجنة مرجعية من قطاعات المياه والزراعة والبيئة والطاقة والقانون، لضمان مراجعة عادلة وواقعية للاتفاقيات.
وحذّر التقرير، الصادر عن مركز القانون الدولي لحقوق الإنسان التابع للجامعة الأميركية العريقة، من أن الأردن يواجه تحديا إستراتيجيا مزدوجا؛ من جهة، الضغط الداخلي المتصاعد بسبب شح المياه وتزايد الطلب؛ ومن جهة أخرى، تعقيدات الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي تتطلب مواءمة السياسات الوطنية مع مبدأ الحق في المياه كحق إنساني عالمي.
خصوصية المياه المشتركة
وفي السياق ذاته، قال الخبير الدولي في المياه عضو لجنة الخبراء التي أعدت "دليل تخصيص المياه العابرة للحدود" محمد ارشيد، إن المياه المشتركة تمثل نحو 40 % من مصادر المياه في المنطقة، فيما لا يتم استخدام أكثر من 20–25 % منها ضمن الموازنة المائية، مؤكدا أنه وفي ظل هذه الأهمية المحورية، لا بد من الاهتمام العاجل بقضية المياه المشتركة على الصعد كافة؛ الفنية، والإدارية، والسياسية.
وأضاف ارشيد أنه كان من أوائل من نبهوا إلى ضرورة تحديث وتطوير الاتفاقيات المتعلقة بالمياه المشتركة، وذلك خلال ندوة أقيمت بتاريخ 12 شباط (فبراير) العام 2021 حول الآفاق المستقبلية للمياه، بحضور خبراء محليين.
وأكد ضرورة التحديث لمواكبة المستجدات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة، مثل التغير المناخي، والنمو السكاني، والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب الحاجة لتصحيح البنود غير العادلة أو المنقوصة في توزيع المياه، كما وردت في اتفاقيات سابقة.
ولتحقيق ذلك، شدد ارشيد على أهمية إعادة تشكيل اللجان المشتركة، بحيث تضم خبراء ومختصين في المياه السطحية والجوفية، إلى جانب لجنة مرجعية تشمل اختصاصيين في مجالات المياه والزراعة والبيئة والطاقة والشؤون القانونية، على أن تكون هذه اللجان محمية بغطاء سياسي، وأن يتمتع أعضاؤها بمعرفة راسخة في قواعد القانون الدولي للمياه، وخاصة "قواعد هلسنكي" المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الدولية، التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة، تعد اتفاقية إطار تحدد القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي يتم بموجبها تقاسم مياه الأنهار الدولية، وعلى رأسها مبدأ "التقاسم المنصف والعادل"، و"عدم التسبب في الضرر"، مع التزام الدولة المتسببة بالضرر بتخفيفه وإزالته وتعويضه إذا لزم الأمر.
وأكد ضرورة الرجوع إلى دليل تخصيص المياه في السياق العابر للحدود، الذي يشكل مرجعية عالمية لترتيبات تخصيص المياه في الأحواض المشتركة، ويحتوي على جميع الخطوات والمراحل الواجب اتباعها عند عقد اتفاقيات تخصيص، كما يضم الدليل 46 حالة نموذجية توضح السمات الرئيسة للتوزيع والتطبيقات العملية لتقاسم المياه.
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية المشتركة، أوضح ارشيد أن القانون الدولي ما يزال يفتقر إلى قواعد قانونية منظمة تحكم استغلال هذه الموارد، لكنه أشار إلى وجود اتجاهات حديثة تؤكد عدم جواز استغلال المياه الجوفية بطريقة تضر بالدول الأخرى المشاركة في الحوض.
وانتقد القصور في الاتفاقيات المبرمة مع الدول المجاورة، التي لم تحقق التوزيع العادل والمنصف للمياه، مشيرا إلى أن بعض هذه الاتفاقيات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مثل اتفاقية جونستون (1953–1955)، التي كانت الكميات المخصصة للأردن فيها أعلى بكثير مما تم تطبيقه لاحقا.
كما لفت إلى وجود تجاوزات كبيرة موثقة علميا عبر صور جوية وتقنيات الاستشعار عن بعد، تشمل بناء سدود، واستخدامات زراعية مفرطة، وغيرها من المخالفات التي أثرت سلبًا على حقوق الأردن المائية، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي في ظل هذه الظروف دون حزمة من الإجراءات الفعلية.
ومن أبرز تلك الإجراءات؛ إعادة النظر وتحديث الاتفاقيات المبرمة مع الدول المشاطئة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل الدبلوماسية المائية، والتوجه نحو الحفر العميق واستكشاف مصادر جوفية جديدة، خصوصا في مناطق واعدة مثل الحماد والسرحان.
كما أوصى بأهمية تنويع مصادر المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وحصاد مياه الأمطار وتحسين كفاءة الاستخدام في كافة القطاعات، وتبني التكنولوجيا والابتكار في إدارة المياه، إلى جانب ضمان تمويل مستدام من خلال شراكات دولية فعالة، والحد من الفاقد المائي، ووضع تشريعات وسياسات داعمة للحوكمة الرشيدة للقطاع.
وأكد ارشيد أن غياب الإرادة الدولية يتطلب تبني سياسات واقعية تستند إلى القدرات الإدارية والفنية المحلية، مع توفر الإرادة السياسية الحقيقية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول الحوض المائي، وصياغة اتفاقيات إقليمية ملزمة، وإنشاء هيئات مشتركة متخصصة، وتبني آليات قانونية مستندة إلى القانون الدولي لدعم حقوق الدول.
كما أكد أهمية تطوير مواثيق إقليمية ملزمة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة والتوزيع العادل والمنصف، والاستفادة من المجتمع المدني وخبراته، والاستثمار في الدبلوماسية المائية، إلى جانب توظيف أدوات القوة الناعمة مثل الاقتصاد والطاقة في خدمة ملف المياه.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية إنشاء منتديات إقليمية للحوار المائي بشكل دوري، وتنفيذ مشاريع إقليمية متكاملة تربط بين الماء والطاقة والغذاء، مع تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، وإنشاء مراكز لرصد الموارد المائية، والاستفادة من التمويل الدولي المشروط بالتعاون الإقليمي.
وأكد ارشيد قدرة الأردن، بما يمتلكه من وزن سياسي وموقع جغرافي، أن يؤدي دورا محوريا في إعادة صياغة مفهوم العدالة المائية في المنطقة، مشددا على أن الأمن المائي ليس مجرد تحدٍ فني، بل قضية إستراتيجية وطنية وأمن قومي تتطلب استجابة شاملة على كافة المستويات.
محاذير من حروب المياه
من جانبه، حذر الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، من احتمال اندلاع حرب إقليمية على المياه في أي لحظة، مؤكدا أن الأردن من أكثر الدول تأثرا بهذا التهديد، خصوصا في ظل اشتراكه في مصادر مياه مع سورية وفلسطين والاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات السلبية تتعارض مع اتفاقية السلام بين الأردن والكيان الصهيوني التي نصت على الحدود المائية بين البلدين.
وقال محاسنة إن أول تداعيات هذا الصراع تمثل في قطع إسرائيل المياه عن قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من الاحتلال، مما يؤكد نية الاحتلال استخدام المياه سلاحا، لافتا إلى أن قوات العدو وصلت إلى مياه نهر اليرموك، التي كانت محصورة بين الأردن وسورية، ووصلت حتى إلى سد الوحدة، وهو ما ينذر بمخاطر جسيمة في حال شرع الاحتلال بالتعدي على المياه الأردنية، خاصة في المناطق المتشابكة مع سورية.
وأضاف إن الاعتداءات لم تقتصر على الأردن، بل شملت لبنان أيضا، حيث بدأ الاحتلال بالتعدي على مصادر الأنهار اللبنانية التي تغذيها مياه اليرموك، وهو أمر في غاية الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بسد الوحدة المشترك بين الأردن وسورية.
وأشار إلى أن الأردن يحصل على ما بين 35 إلى 40 % من مياه حوض اليرموك من سورية، وهو نصيب لم يكن متاحا في فترات سابقة، معربا عن أمله في أن يكون هذا تطورا يسهم في استعادة حقوق الأردن في مياه الحوض.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أي ضرر صهيوني لهذه المصادر سيقلل من مياه نهر الأردن، ما سيؤثر ليس فقط على إمدادات المياه الصالحة للشرب، بل على مصادر المياه الأخرى.
وأكد محاسنة أن تحقيق الأمن المائي، الذي يعد جزءا من الأمن الوطني، يتطلب تنظيم الإدارة المائية في الأردن بشكل عاجل، معبرا عن استغرابه إزاء استمرارية صرف كميات كبيرة من المياه على الزراعة بدون جدوى اقتصادية.
وأشار إلى أن ما بين 55 إلى 60 % من المياه تستخدم في الزراعة دون مردود مادي حقيقي، مشددا على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تحلية المياه والتنقيب عن المصادر الجوفية العميقة، إلى جانب تأسيس شركة مساهمة عامة للمياه، وهو ما أصبح ضرورة ملحة.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات في منطقة العقبة، وألا يقتصر ذلك على مشروع الناقل الوطني فقط، بل أن يشمل كافة الاستثمارات القائمة هناك.
وفي الوقت نفسه، أكد محاسنة أهمية منع الاعتداءات والتجاوزات على الموارد المائية، لا سيما في مختلف المحافظات، حفاظاً على الأمن المائي للمملكة.
تقاطع حرج
من جهته، أكد المستشار الإقليمي في شؤون المياه في السفارة السويسرية مفلح العلاوين، أن المملكة تواجه واحدة من أخطر الأزمات المائية في المنطقة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه المتجددة لا يتجاوز 80 مترا مكعبا سنويا، وهو من الأدنى عالميا.
وبيّن العلاوين أن الأردن يقف عند تقاطع حرج من العجز المائي الذي يهدد الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، في ظل تأثيرات متزايدة لتغير المناخ، وضغوط النزاعات الإقليمية، والاستنزاف الحاد للموارد الطبيعية، فضلًا عن النمو السكاني المتسارع وتكرار موجات اللجوء.
وأشار إلى أن المياه الجوفية تُشكل أكثر من 56 % من مصادر المياه في الأردن، بينما لا تتجاوز مساهمة المياه السطحية والسدود 28 %، موضحا أن نحو 15 % من المياه تتم معالجتها وإعادة استخدامها، في حين يشكل الباقي مياه محلاة، وسط تراجع كبير في مخزون السدود نتيجة قلة الأمطار في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على ما يقارب 50 % من الاستخدامات المائية، ما يشكل ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة، مضيفا إن ارتفاع درجات الحرارة في الأردن تجاوز 1.5 إلى 2 درجة مئوية خلال العقود الماضية، ويتوقع أن ترتفع أكثر بحلول نهاية القرن الحالي، وهو ما يرافقه تراجع في معدلات الهطول المطري وامتداد مواسم الجفاف.
كما حذر من أن السحب المفرط من الأحواض الجوفية أدى إلى تدهور جودة المياه وارتفاع ملوحتها، ما يتطلب تدخلات معالجة عالية التكلفة.
وفي هذا السياق، نوّه العلاوين بأن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع "الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة"، والذي يعد من أضخم المشاريع من نوعه في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يؤمّن نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة، ما يعزز استدامة التزويد المائي لعقود مقبلة.
كما أشار إلى توسع الأردن في استخدام المياه المعالجة، إذ يتم إنتاج ما بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب سنويا، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في المحافظات.
وأكد اعتماد الأردن تقنيات ري ذكية، كأنظمة الحساسات لقياس رطوبة التربة في المزارع الواقعة في وادي الأردن، وهو ما أسهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 30– 50 % في بعض المناطق، كما أشار إلى إطلاق برامج وطنية لتقليل الفاقد، وتطوير أنظمة بيانات متكاملة لإدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة وتحقيق الاستدامة.
أما فيما يتعلق بالمياه المشتركة العابرة للحدود، فبيّن العلاوين أن الأردن يعتمد على مصادر مائية رئيسة مثل نهر اليرموك ونهر الأردن، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن بناء اتفاقيات مائية تستند إلى مبادئ القانون الدولي هو السبيل لتحقيق العدالة في التوزيع وضمان الاستدامة.
وأشار إلى أهمية مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول" الذي يراعي مساحة الحوض، وعدد السكان، والحاجات البيئية، وظروف المناخ، إضافة إلى مبدأ "عدم التسبب في ضرر جسيم" لأي دولة من دول الحوض، وضرورة الالتزام بالإخطار والتشاور المسبق قبل تنفيذ أي مشاريع قد تؤثر على كمية أو نوعية المياه.
وأكد ضرورة تأسيس هيئة أو مجلس مشترك لإدارة الأحواض المائية، يتولى مهام تبادل المعلومات حول المصادر والاستخدامات وخطط الطوارئ، مع مراجعة دورية لبنود الاتفاقيات كل عدة أعوام لضمان مواكبتها للتغيرات السكانية والمناخية المستجدة.
سد الفجوات القانونية
وبالعودة إلى تقرير "ميدل إيست مونيتور"، فقد أوصى بضرورة تعديل الاتفاقيات المائية الثنائية، وخاصة مع سورية وإسرائيل، لتشمل آليات واضحة لفض النزاعات وتعويض المتضررين عند الإخلال بحصص المياه، وأهمية سد الفجوة القانونية عبر الاعتراف الدستوري الصريح بالحق في المياه، بما يعزز قوة الالتزام الحكومي ويمنح هذا الملف أولوية دستورية.
وذلك إلى جانب أهمية إعادة هيكلة الأدوار المؤسسية في قطاع المياه، لتوضيح المسؤوليات وتقوية المساءلة، وتجاوز التداخلات الإدارية المربكة، والتعاون في المياه المشتركة؛ من الاحتياج إلى الإستراتيجية.
وفي المحور المتعلق بالمياه المشتركة، شدد التقرير على أن التعاون عبر الحدود لم يعد خيارا دبلوماسيا، بل ضرورة إستراتيجية.
فالمياه العابرة للحدود، كما هو حال نهري اليرموك والأردن، تتطلب اتفاقيات مرنة ومحدثة، قادرة على الاستجابة للظروف المناخية والسياسية المتغيرة، لا سيما مع تكرار مواسم الجفاف وشح الأمطار.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاقيات القائمة تعاني من قصور في آليات التنفيذ، وضعف في ضمان الحصص المقررة، وغياب أدوات فعالة لحل النزاعات، وهو ما يضعف قدرة الأردن على التخطيط طويل الأمد لموارده المائية.