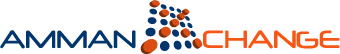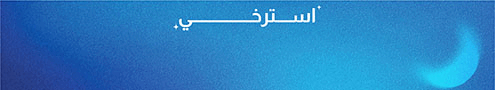المواضيع الأكثر قراءة
- "أدّت لتدهور الاقتصاد".. استطلاع: 59% من الأميركيين ينتقدون سياسات ترامب
- صندوق جديد بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة
- صندوق دعم الصناعة يرفع التصدير والتطوير لـ368 شركة بالجولة الأولى
- صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمراً حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة
- ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية إلى 53 مليار دينار جزائري
- الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني تقر توزيع 25 % أرباحا نقدية على المساهمين
- «المركزي السعودي» يرخّص لشركة تزاول نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
المديونية العالمية: أرقام صادمة وتداعيات متفاقمة*د.عدلي قندح

الدستور
تشهد المديونية العالمية ارتفاعًا غير مسبوق، إذ تجاوز إجمالي الدين العام العالمي 102 تريليون دولار عام 2024، ما يعادل نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. هذا التصاعد يعكس اختلالات مالية وهيكلية عميقة ناتجة عن إنفاق حكومي ضخم عقب جائحة كوفيد-19، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد السياسات النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، مما رفع كلفة الاقتراض وخدمة الدين.
تتركز المديونية بشكل غير متوازن، إذ تستحوذ الولايات المتحدة، الصين، واليابان على أكثر من نصف الدين العالمي. فالولايات المتحدة هي الأكبر دينًا بقيمة تفوق 36 تريليون دولار (122% من ناتجها المحلي)، تليها الصين بـ16.5 تريليون دولار (83% من ناتجها)، ثم اليابان بـ11 تريليون دولار، ما يمثل 256.3% من ناتجها المحلي، وهي النسبة الأعلى عالميًا.
هذا التركّز في ثلاث دول فقط يضاعف المخاطر المحتملة على استقرار النظام المالي العالمي، خاصة إذا واجه أحدها أزمة مالية أو تباطؤًا اقتصاديًا حادًا. كما تؤثر المديونية المرتفعة على الموازنات العامة، حيث تستهلك خدمة الدين نسبًا متزايدة من الإنفاق الحكومي. ففي الولايات المتحدة وحدها، تجاوزت مدفوعات الفائدة عام 2024 حاجز التريليون دولار، بما يعادل 13% من موازنتها، مما يؤدي إلى «تزاحم الإنفاق» على حساب مجالات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
في القطاع الخاص، تتسبب هذه الظروف في رفع أسعار الفائدة عمومًا، ما يزيد كلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات على الاستثمار. كما تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. وفي القطاع المصرفي، ترتفع المخاطر السيادية على البنوك التي تمتلك أدوات دين حكومية، مما يهدد استقرارها وقدرتها على الإقراض في حال اهتزاز الثقة أو التخلف عن السداد.
أما السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع 2025، فقد زادت الضغوط على المشهد المالي العالمي، خصوصًا من خلال رفع الرسوم الجمركية، والتي وفرت 166.6 مليار دولار من العائدات الأمريكية، لكنها أربكت سلاسل التوريد، وأدت إلى تراجع التجارة العالمية وارتفاع أسعار الواردات، مما أضعف النشاط الاقتصادي وزاد هشاشة أوضاع الدول النامية. كما مارس ترامب ضغوطًا لخفض سعر صرف الدولار ونجح في خفضه بنسبة تراوحت بين 8% و10% خلال ثلاثة أشهر، مما زاد من كلفة خدمة الديون المقومة بالدولار بالنسبة للدول النامية، وأثار تساؤلات حول استقراره كعملة احتياط عالمية.
تُوظَّف المديونية أيضًا كأداة جيوسياسية، كما تفعل الصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، حيث تستخدم القروض لتمويل مشاريع في الدول النامية مقابل امتيازات سيادية. كما أن تركز الديون في عدد قليل من الدول يفاقم من هشاشة الأسواق العالمية، خاصة في ظل ضعف التنسيق الدولي. ورغم دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة المديونية، إلا أن شروط الإقراض الصارمة كثيرًا ما تُتهم بزيادة أعباء الدول النامية.
في الوقت ذاته، تبرز العملات الرقمية السيادية، مثل اليوان الرقمي، كمؤشر على تحول تدريجي في النظام النقدي الدولي، بما قد يعيد تشكيل موازين القوى المالية خلال السنوات المقبلة.
تجربة المملكة المتحدة تقدم مثالًا على العلاقة الوثيقة بين تباطؤ النمو وتصاعد الدين العام، حيث حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من «صدمة نمو»، متوقعًا تراجع النمو إلى 1.1% في 2025 مقارنة بـ1.6% سابقًا. هذا التباطؤ يُضعف الإيرادات الضريبية، ويرجح زيادة العجز والمديونية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على السياسات المالية والنقدية.
أما الحالة الأردنية، فهي نموذج لدول تعاني من تحديات هيكلية في المديونية. فقد بلغ الدين العام الأردني حتى نهاية 2024 نحو 44.161 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، ما يمثل 116.8% من الناتج المحلي. ويعود ذلك إلى العجز المزمن، والاعتماد على التمويل الخارجي، والتداعيات الإقليمية، وجائحة كورونا. وتسعى الحكومة لمعالجة ذلك من خلال خطة إصلاح مالي بالتعاون مع صندوق النقد، تستهدف خفض الدين إلى 79% بحلول 2028، عبر تحسين التحصيل الضريبي، وترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
ولمواجهة أزمة المديونية العالمية، تبرز الحاجة إلى حزمة من السياسات أهمها: تحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في البنية التحتية والإنتاجية، إصلاح الأنظمة المالية العامة بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل، وخفض الهدر. كما تُعدّ إعادة هيكلة الدين أداة فعالة عبر تمديد الآجال، خفض الفوائد، أو إصدار أدوات بشروط أفضل. ولا بد من تنسيق السياسات النقدية والمالية، وضمان الشفافية والمساءلة، لاستعادة ثقة المستثمرين.
إن التصدي لأزمة المديونية العالمية يتطلب مزيجًا دقيقًا من الانضباط المالي، والحكمة في الإنفاق، والشجاعة في الإصلاح، تجنبًا لما هو أخطر.